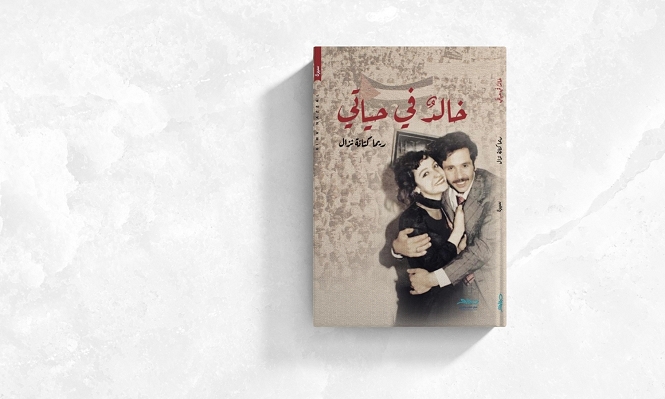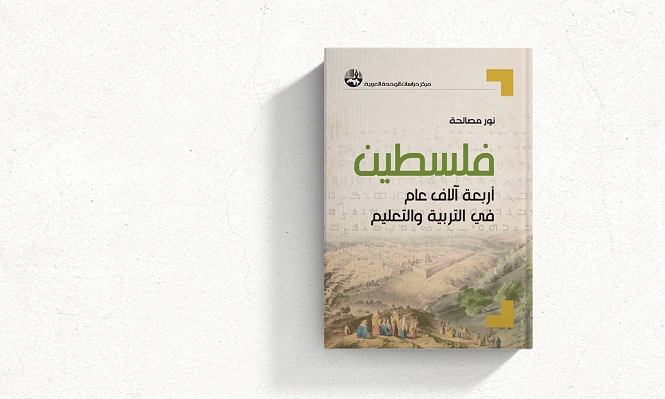تمثيل الحرّيّة في المجتمعات العربيّة | فصل

في كتابه «الصدع الكبير: محنة السياسة والأيدلوجيا والسلطة في اختبارات الربيع العربي» (2021) «المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر»؛ يتلمّس ماجد كيّالي أسباب استعصاء التغيير في تجارب «الربيع العربيّ». الكتاب هو محاولة في التفكير السياسيّ، تناول في أقسامه الأربعة اختبارات الدولة والمواطنة والديمقراطيّة في العالم العربيّ، ومصادر الصراعات الطائفيّة والإثنيّة في أبعادها ومصائرها، وإشكاليّة الدينيّ والدنيويّ في السياسة والدولة، ومشكلات تجربة التغيير السياسيّ في سوريا.
تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة فصلًا من الكتاب بإذن من الناشر.
***
هكذا، بدا إنّ الثورات الشعبيّة الّتي اندلعت، في بعض البلدان العربيّة، تتوخّى تحقيق الحرّيّة والكرامة والعدالة، أكثر من أيّ شيء أخر، أيْ على خلاف أجندات تلك الأحزاب والتيارات، إذ وضعت نصب عينيها التخلّص من نظم الاستبداد والفساد الّتي شكّلت، لأكثر من نصف قرن، حاجزًا صلبًا أمام تطوّر الأحوال السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في العالم العربيّ.
بيد إنّ تلك التجربة بيّنت أنّ النظم السلطويّة السائدة لن ترحل بسهولة، وأنّ الأحوال لن تتغيّر بيسر، أو من دون تعقيدات ومعوّقات وأثمان كبيرة، كما بيّنت، على وجه الخصوص، بأنّ تلك الثورات تكابد من مشكلة أساسيّة ستؤثّر كثيرًا على مساراتها، ومستقبلها، وهي المتعلّقة بالإجابة على معنى الحرّيّة، وهي الشعار الجامع لها وللقوى المنخرطة فيها، لاسيّما أنّ هذه القوى، بتنويعاتها (العلمانيّة أو الدينيّة أو الوطنيّة أو اليساريّة أو القوميّة)، كشفت عن ضعف تمثّلها لهذا المعنى في إدراكاتها، وفي سلوكيّاتها السياسيّة؛ وذلك على رغم ميلها نحو الديمقراطيّة.
وفي غضون التجربة المعاشة بتنا في مواجهة مساريْن مختلفين ومتمايزين: الأوّل، يجري فيه التشديد على الديمقراطيّة، وتشكيل الأحزاب والانتخابات، وتداول السلطة والاحتكام لإرادة الشعب باعتباره مصدرًا للسلطة. والثاني يتمّ فيه الاشتراط على معنى الحرّيّة وحدودها، بالنسبة للمواطن الفرد، بدعوى خضوع الأقلّيّة للأكثريّة، وبدعوى الحفاظ على الخصوصيّات والعصبيّات الهوياتيّة (الدينيّة أو الإثنيّة)، لكأنّ الثورات تناقض نفسها، أو تقيّد نفسها.
التيّار اليساريّ، في معظم كياناته الرسميّة، يرى المجتمع تكوينًا مُهَنْدَسًا، أو منمّطًا، في طبقات عدّة، فقط، بحسب الموقع من ملكيّة الإنتاج وعلاقات الإنتاج
مثلا، فإنّ التيّار اليساريّ، في معظم كياناته الرسميّة، يرى المجتمع تكوينًا مُهَنْدَسًا، أو منمّطًا، في طبقات عدّة، فقط، بحسب الموقع من ملكيّة الإنتاج وعلاقات الإنتاج، على أساس أنّ الانتماء الطبقيّ يحدّد الوعي الطبقيّ، هكذا بشكل مسبق، لا باعتباره يتألّف من مواطنين، مختلفين ومتعدّدين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم الطبقيّة. والمعنى أنّ تلك الرؤية ذات طابع أيدلوجيّ، أكثر منها نتاجًا لقراءة مطابقة للواقع المتعيّن، ولطبيعة الانقسامات الطبقيّة، ومعناها، في مجتمعات تفتقر إلى مثل تلك التراتبيّة المتمايزة بتلك الدقّة، رغم وضوح انقسامها إلى فقراء وأغنياء ووسط، بحكم تشوّه البنى الاقتصاديّة، وهي حتّى ولو انقسمت على هذا النحو، فإنّ تمثّل وعي كلّ طبقة لذاتها تشوبه عديد من الالتباسات والمداخلات. فضلًا عن ذلك فإنّ هذا التيّار يعتقد بأنّ دوره التاريخي يتحدّد في القضاء على الملكيّة الخاصّة، وإقامة المجتمع الاشتراكيّ، بغضّ النظر عن ملاءمة الظروف والمعطيات والحاجات إلى ذلك من عدمه. وكنّا شهدنا النتائج الكارثيّة للتأميمات الحاصلة في مصر وسوريا، على سبيل المثال، في الخمسينيّات والستينيّات، والّتي قوّضت البنى الجنينيّة للبرجوازيّة الصناعيّة (الوطنيّة) في مصر وسوريا، في حين نشأ بدلًا عنها نوع من بورجوازيّة طفيليّة ناشئة في حضن الدولة التأميميّة ذاتها؛ إذ التهمت السلطة الدولة والمجتمع والموارد، في نظام الليبراليّة المتوحّشة.
يجدر لفت النظر هنا إلى أنّ ثمّة في العقيدة الشيوعيّة مفهومًا مركزيًّا ينطوي على عداء للديمقراطيّة، كما لاحظت ذلك حنّة آرندت[1]، وهو يتمثّل في فكرة «ديكتاتوريّة البروليتاريا»، الّتي شرّعت اختزال الشعب في طبقة ثمّ في حزب، وبعده في مكتب سياسيّ أو أمين عام، وكانت بمثابة وصفة لمصادرة الحرّيّات الفرديّة وسيادة الاستبداد. وتلك الفكرة بالذات، أي الدكتاتوريّة، والجوع إلى الحرّيّة، لعبت دورًا كبيرًا في انهيار الاتحاد السوفييتيّ (السابق)، على ما رأى زبينغيو بريجنسكي المستشار الأسبق للأمن القوميّ الأميركيّ (عهد كارتر)، الّذي كان تحدّث عن انهيار الاتحاد السوفيتيّ، في كتابه الشهير: «بين عصرين»، الّذي صدر قبل عقدين من حدوث ذلك، أي عام 1970[2]. هذا يفيد بأنّ مشكلة «اليسار» قديمة، وليست وليدة الثورات العربيّة، الّتي ربّما كشفته أكثر من أيّ وقت مضى، في تماهيه مع نظام الاستبداد الأسديّ، بدعوى صدّ المؤامرة الإمبرياليّة، أو تبييضه صفحة حزب الله، الّذي يقاتل السوريّين، بدعوى الحفاظ على مقاومة متوقّفة منذ العام 2000، باستثناء لحظة خطف جنديّين إسرائيليّين، الّتي استجرّت حربًا إسرائيليّة مدمّرة على لبنان (2006)، واضطّرت الأمين العام لحزب الله أن يبدي اعتذارًا عن تلك العمليّة، بسبب الأثمان الباهظة الّتي دفعها لبنان في تلك الحرب.
ثمّة في العقيدة الشيوعيّة مفهومًا مركزيًّا ينطوي على عداء للديمقراطيّة، كما لاحظت ذلك حنّة آرندت، يتمثّل في فكرة «ديكتاتوريّة البروليتاريا»
ولسنا بحاجة هنا للحديث كثيرًا عن التيّار "القوميّ"، فهذا التيّار، في أغلب كياناته السائدة، هو الذي غطّى الأنظمة الاستبداديّة في العالم العربيّ، وروّج لها، وبرّر سياساتها، لا سيّما تلك المتعلّقة بمصادرة الحرّيّات، وتأخير عمليّة التنمية، وإعاقة الدولة الوطنيّة، باعتبارها مجرّد دولة قطريّة، وكلّ ذلك بدعوى القضيّة المركزيّة، أي قضيّة فلسطين، والتركّز في مواجهة إسرائيل والإمبرياليّة. وبالنتيجة فإنّ الأنظمة الّتي تأسّست على هذا النحو ليس فقط أجهضت أيّ محاولة للتكامل والتوحّد العربيّين، وإنّما هي لم تفلح حتّى في بناء إجماعات وطنيّة، في مجتمعاتها، إذ إنّها عاشت على سياسة «فرّق تسد»، بمحافظتها على الانتماءات والعصبيّات القبليّة، أيْ العشائريّة والطائفيّة والإثنيّة، باعتبارها جزءًا من منظومتها للسيطرة، ناهيك إعاقتها لإقامة دولة المؤسّسات والقانون والمواطنين، وهذا ما حدث في تجربة البعث في سوريا والعراق وإبّان حكم القذافي لليبيا.
ولا يبدو التيّار الإسلامي، في معظم تشكيلاته، أحسن حالًا، فهو بدوره يقسّم المجتمع على أساس دينيّ إلى مسلمين وغير مسلمين، أو مؤمنين وغير مؤمنين، ما يقوّض مفهوم الهويّة الوطنيّة، والمواطنة المدنيّة والوحدة المجتمعيّة، الّتي تفترض المجتمع تعبيرًا عن مجموع المواطنين الأحرار المتساوين أمام القانون، وإزاء الدولة، كما إنّه لا يشرعن الدولة القائمة لإيمانه بالدولة الإسلاميّة أو دولة الخلافة. وهذا التيّار يعتقد بأنّ حصوله على أكثريّة في الانتخابات، يخوّله أخذ الدولة والمجتمع حيث يريد وفرض الدستور والتشريعات الّتي تتلاءم مع عقيدته الدينيّة على الدولة الدنيويّة (مع ضمان حق «الملل» الأخرى في فرض شرائعها على أتباعها)، وهذا ينطبق على مناحي التعليم والإعلام. وهذا ما سنأتي عليه بتفصيل أكثر، في مناقشتنا لتجربتيّ مصر وتونس.
العلمانيّون (الأيدلوجيّون)، بدورهم، لا يشذّون كثيرًا عن تلك القاعدة؛ فلدى كثر منهم تقسيماتهم ومخاوفهم وهواجسهم، رغم الاعتقاد الرائج أو المفترض بأنّهم أقرب ميلًا إلى حرّيّة التفكير والتعبير. ففي حيّز الممارسة يتكشف كثير من هؤلاء، مثلهم مثل قطاعات من اليساريّين والإسلاميّين والقوميّين، عن مستبدّين من نوع آخر؛ إذ يستكثرون على غيرهم الحرّيّة وحتّى الديمقراطيّة، وقد يصل بعضهم حدّ استمراء الاستبداد السياسيّ المغلّف بإطارات علمانيّة، كونه يضمن نمط عيشهم، على الديمقراطيّة الّتي قد تحرمهم من ذلك (كما يحصل مع كيانات «يساريّة» اليوم). ومعلوم أنّ العلمانيّة تختلف عن الإلحاد، وهي سليلة ثورات الإصلاح الدينيّ والعقلانيّة والحدّ من سلطة رجال الدين ومن تدخّلهم في شؤون الدنيا، بإعطاء "ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، وعدم تسييس الدين أو تديين السياسة، أي استغلال أحدهما للآخر لأغراض السلطة والتسلّط.
قصارى القول، نحن هنا إزاء إشكاليّة كبيرة وعميقة بشأن معنى الحرّيّة في الثورات العربيّة تنبثق من عدّة مستويات، بعضها سياسيّ نابع عن الغياب التاريخيّ للمشاركة السياسيّة ولتقاليد العمل السياسيّ والحزبيّ، وعن الخضوع لأنظمة استبداديّة لقرون. وبعضها اجتماعيّ اقتصاديّ ناجم عن ضعف التمدين وعن تخلّف الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في المجتمعات العربيّة. وبعضها ناجم عن سياسات «الهويّة» في هذه المنطقة، الّتي تعمل على ترسيخ الانقسامات العموديّة (الدينيّة والإثنيّة)، وإضعاف مسارات الاندماج المجتمعيّ في البلدان العربيّة، وتغييب المواطن الفرد.
ثمّة أيضًا أنّ الثورات الحاصلة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجتمعات العربيّة، وأنّ هذه المجتمعات تتوخّى الدخول مباشرة في الثورة الديمقراطيّة، على خلاف التجربة الأوروبيّة، أي من دون المرور في ثورة العلمنة وتحرير العقل، ومن دون الدخول في الثورات الليبراليّة الّتي أدّت إلى تحرير الفرد بوصفه قيمة عُلْيا، وإلى اعتبار المواطن الوحدة الأساسيّة في المجتمع، بعيدًا عن أيّة تنميطات أو انتماءات أخرى (على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الوضع الطبقيّ)؛ وهما أمرين لا يبدو أنّ بمقدور الثورات الراهنة تحقيقهما في ظلّ هيمنة سياسات الهويّة والتنميطات الجمعيّة العموديّة.
الديمقراطيّة في البلدان العربيّة قد تبقى ناقصة ومشوّهة، وقد تنطوي على ما يثير المخاوف، إذا لم تتطعّم بحمولات ليبراليّة
وإذا كان يمكن القول بأنّ الثورات التحريريّة «الليبراليّة» في أوروبا استوعبت أو هضمت العلمانيّة، أو هذّبتها، فإنّ فكرتيّ الحرّيّة والمواطنة الفرديّة/المدنيّة لم يكن بالإمكان هضمهما أو تجاوزهما في الديمقراطيّة، الّتي تتعلّق بكيفية تنظيم العلاقات وإدارتها في المجتمع وبين المجتمع والدولة، إلّا من خلال الديمقراطيّة الدستوريّة، أو من خلال ما بات يعرف بالديمقراطيّة الليبراليّة، لأنّ الحمولات الليبراليّة هي الّتي ترشّد الديمقراطيّة وتضبطها بحيث لا تتحول إلى نوع جديد من استبداد أكثريّة، برلمانيّة أو تصويتيّة (دينيّة أو إثنيّة أو عرقيّة) بأقلّيّة، وبحيث يتمّ ضمان حرّيّات المواطنين الأفراد، ومساواتهم أمام القانون بصفتهم المدنية.
هذا يعني أنّ الديمقراطيّة في البلدان العربيّة قد تبقى ناقصة ومشوّهة، وقد تنطوي على ما يثير المخاوف، إذا لم تتطعّم بحمولات ليبراليّة، تتعلّق بالحرّيّة والمواطنة وإعلاء شأن الإنسان الفرد، وضمن ذلك ضمان حقه في الاختيار والمساواة وتكافؤ الفرص.
على أيّة حال يجدر بنا التذكير هنا، أيضًا، بأنّ إشكاليّة الديمقراطيّة والليبراليّة هي إشكاليّة خاصّة بأوضاعنا، على خلاف التجربة الأوروبيّة الّتي عرفت حقبة الإصلاح الدينيّ والنزعة العلمانيّة أولًا، ثمّ حقبة العقلانيّة متلازمة مع حقبة الليبراليّة، ثمّ حقبة الدولة الديمقراطيّة الليبراليّة، كما سبق أن قدّمنا؛ وهذا بعض ما يفسّر إجماعاتنا على قضيّة الديمقراطيّة وانقساماتنا من حول قضيّة الحرّيّة.
إحالات
[1] تجادل حنّة آرندت في كتابها: «في الثورة» بأنّ الماركسيّة ليست على وفاق مع الديمقراطيّة وتأخذ عليها أنّها لم تول مسألة الحرّيّة الأولويّة المفترضة (89-88)
[2] زبينغيو بريجنسكي المستشار الأسبق للأمن القومي الأميركي (عهد كارتر): «بين عصرين- أمريكا والعصر التكنتروني»، دار الطليعة، لبنان، 1980.

كاتب فلسطيني من مواليد مدينة حلب (1954). يكتب في الشؤون الفلسطينيّة، و الصراع العربيّ – الإسرائيليّ. له العديد من الكتب «فلسطينيّون 48 والانتفاضة» (1991)، «التسوية وقضايا الحلّ النهائي» (1998)، «مشروع الشرق الأوسط الكبير» (2007).